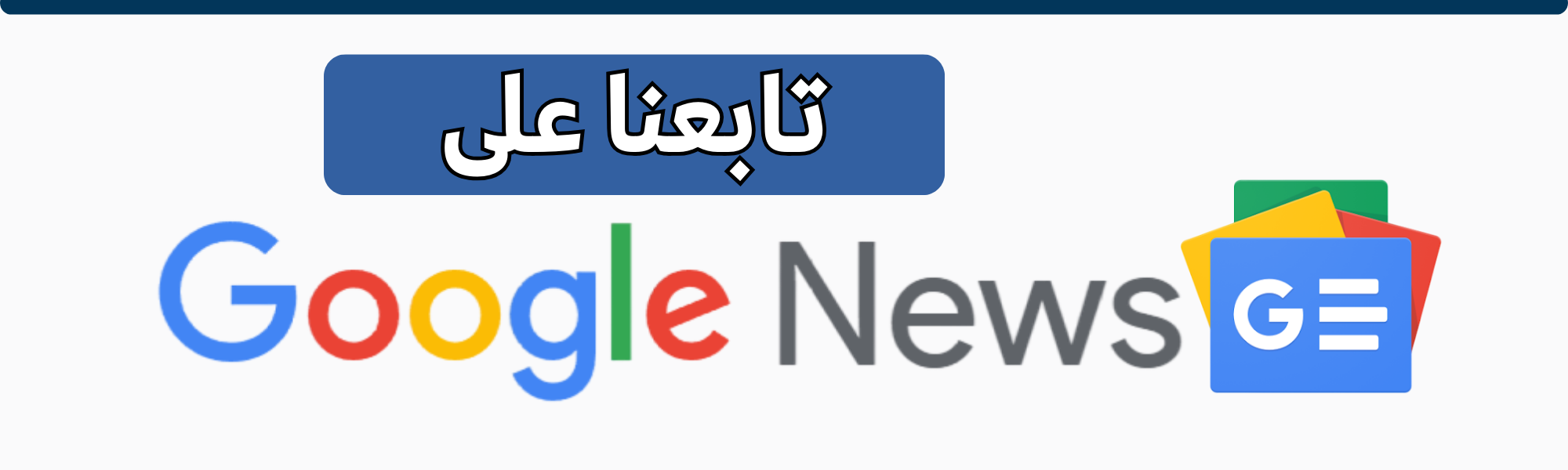المشكل اﻷساسي مع “التنوير العلماني” عندنا أنه فارغ، وغالب مدّعيه يسيرون بالوراء، فمنهم من يتقمص شخصية “روجر بيكون” أو “فرانسيس بيكون” وهؤلاء كانو يسيرون إلى اﻷمام في علوم الطبيعة بتقليدهم لمنهج علماء التجربة المسلمين.
وغالب “التنوير العربي” المزعوم لن تجده مركزا على تأسيس كيانات لترجمة العلوم والكتب التجريبية الحديثة أو شرحها أو حتى تعليم لغة التواصل مع هذه العلوم، لأن هذا يعتبر أمرا ثانويا واﻷصل عنده هو التنقيص ومحاولة البروز والصراخ، ومن معتنقيه من لم ينفع حتى كينونته القريبة، ومنهم من يصر على إلحاقنا بأمم تجاوزها قطار العلم كفرنسا مثلا.
“الدونكيشوتية التنويرية العربية” أقصى حدودها الصراع مع الرياح
السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان ابن الهيثم ظلاميا في تناسقه في الجمع بين الاعتراف والتمسك بثوابت الدين وتأسيسه للمنهج التجريبي القائم على الملاحظة اﻵمنة؟!
وهل كان البيروني متخلفا عندما أصل لبحثه انطلاقا من اكتشاف ملكوت الله؟!
والخوارزمي بدوره هل كان جاهلا عندما ذكر أن من أهداف تأليف الجبر والمقابلة هو نفع المسلمين في المواريث والزراعة وغيرها؟!
فحتى “روجر بيكون” وبريطانيا عموما في نهضتها لم يكن هدفها هو الخروج على السياق الديني بل كان هدفهم التوسع في علوم الطبيعة بتجاوز “المنهج اﻷرسطي”.
ولنا أن نتساءل: هل المسلمون لم ينتقدو المنهج اﻷرسطي؟!
إذ نجد أن ابن تيمية الذي تعتبرونه فقيها وتهاجمونه بالماضوية والرجعية انتقد “المنطق اﻷرسطي”، واعتبر التجربة القريبة من آليات المعرفة، وأقر أن العقل الصريح مهم ولا يمكن أن يناقض النقل الصحيح.
وقد بيّن ابن تيمية كذلك أن الطب تجربات وقياسات، حيث قال: «الطب تجربات وقياسات، وأهله منهم من تغلب عليه التجربة، ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس أصله التجربة، والتجربة لا بد فيها من قياس.. فلا بد من الحسّيات التي هي الأصل ليعتبر بها، والحسّ إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط».
ويقول “روجر بيكون”: “إن شرط تعلم العلوم الطبيعية هو أن تدرس اللغة العربية.
دور المؤسسات الدينية:
“بيت الحكمة” في بغداد كان مشروعًا ثقافيًا مدعومًا من الخلافة العباسية (سلطة دينية-سياسية)، ما يؤكد أن الدين لم يكن عائقًا أمام العلم التجريبي، بل كان حاضنًا له في كثير من المراحل. وهذا ينسجم مع الاستنتاج بأن الصراع في الحضارة الإسلامية لم يكن بين الفقهاء والعلماء التجريبيين، بل كان مع التيارات الفلسفية الدخيلة.
انفكاك الجهة في المسألة:
العلماء المسلمون مثل الخوارزمي (الرياضيات) وابن النفيس (الطب) لم يواجهوا اتهامات ومعارضات من الفقهاء؛ لأنهم التزموا بمنهجية علمية لم تتعارض مع الإطار الديني.
فابن النفيس نفسه كان فقيهًا شافعيًّا، وابن الهيثم اعتبر التجربة طريقًا لفهم “الحكمة الإلهية”، مما يدعم فكرة التكامل بدل الصراع الذي يدعيه التنويريون المزعومون.
أما الصراعات الفكرية فكانت موجهة غالبًا نحو محاولات إدخال التأويلات العقلية في فهم الغيب أو تحريفها، وليس ضد العلماء الذين سعوا لفهم العالم الطبيعي من خلال المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة؛ وهو ما يفسر الازدهار الكبير للعلوم التجريبية في الحضارة الإسلامية.
يقول روبرت بريفولت، مؤلف وروائي وعالم فرنسي في الانتربولوجيا في [كتاب “صنع الإنسانية” ص:200]: “إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي في مدرسة أوكسفورد على يد تلامذة العرب المسلمين، وليس لروجر بيكون ولا لسميِّه الذي جاء بعده ( فرانسيس بيكون) الحق في أن يُنسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي، فلم يكن بيكون إلا رسولاً من رُسل العلم والمنهج الإسلامي التجريبي إلى أوروبا المسيحية”.
كل هذا، ونجد أحدهم في هذا الزمان بعد انتهائه من التنظير لأغراض السمن البلدي والطاجين -وذلك خارج المختبر- يستدل علينا بشيء لا يعارضنا ولم يجد فيه أوائلنا المعارضة وهم مؤسسو العلوم وواضعوها.
تقول الكاتبة والباحثة الألمانية “زيغريد هونكه” في كتابها “شمس الله تشرق على الغرب”: “إن الغرب يعترف فقط بأن المسلمين حافظوا على علوم الحضارات السابقة وقاموا بتنظيمها، ولكن يغيب عنهم أنهم كانوا المؤسسين لعديد من العلوم التي أثرت بشكل كبير على تطور العلم في شكله المعاصر”.
نعم هذه هي الحقيقة، والتاريخ يظهر جليا أنه في كنف الفقهاء وعلماء الحديث تأسست كثير من فروع العلوم التجريبية بكل أريحية بل وفي أقوى عصور الفقهاء؛ وفي المقابل مع ورود العلمانية على العالم الإسلامي لم يحصل أي شيء من ذلك.
من تاجر مع الناس سنين عددا في اﻷعشاب دون مرجعية بحثية حقيقة “أي مختبرية على حد قوله” يدعي اليوم أنه يقدم المختبر، بل يريد أن يلبس ثوب العلم وهو بعيد عن ذلك بعد المشرقين.
فمن الباحثين من قارن في بحثه بين ابن تيمية وديكارت في نقدهم للمنطق اﻷرسطي وهو فقيه، وفي نفس الوقت الناس لا يهتمون لمن مقدماته كبراها وصغراها وقضاياه معها فارغة ولن تعطي نتائج قطعا واستقراء.
ونختم بقول “جوزيف بريتستلي”: “العرب كانو ينابيع العلم، مسلمو الأندلس علموا العالم”.