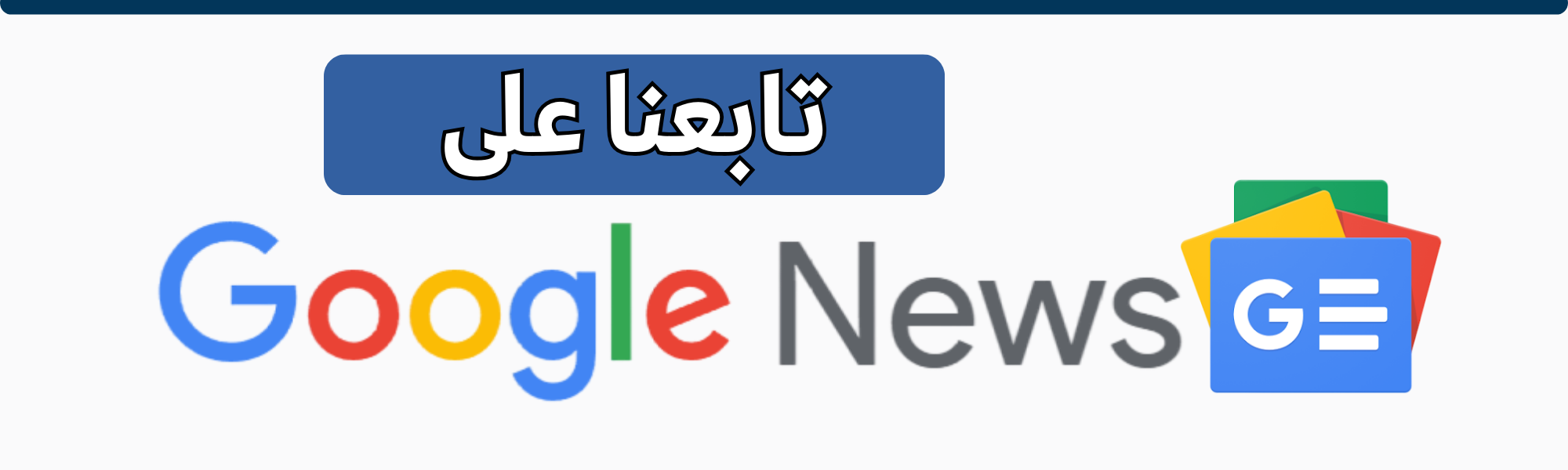مدار العلم هو الصدق سواء في النقل أو التجريب أو النظر العقلي فما بالك بالوجدان، وقد يسأل سائل: لماذا أدرجت التجربة هنا وهي شيء آمن قابل للتكرار؟
وجوابه: لقد أثبت الرأسمال والمصالح النفعية قدرتها على ترويض التجربة وتحييدها للجانب والنتائج المرادة لخدمة الأرباح بل الإديولوجيات تفعل ذلك.
فمثلا الدراوينية يوجد من مؤيديها من زوّر الحقائق لعقود وغشّ شبابا على مدرجات الجامعات بأحافير وهمية أو حتى عن طريق حشر فرضيات مُبعدة وإعطائها الصبغة العلمية.
أنت الآن تتساءل: أين الدليل؟ سأعطيك أوضحهم وأترك لك البحث والاستقصاء.
فضيحة عالم اﻷنثروبولوجيا اﻷلماني “راينر بروكا”، وهو أستاذ سابق في جامعة فرانكفورت خلال 30 سنة قدم تأريخات ﻷحافير بشرية في أوروبا الغربية وقد تم الاعتماد عليها بحثيا؛ جميل أليس كذلك؟ لكن سنة 2004 تم تفجير حقيقة المفاجأة:
– زوّر تواريخ الكربون المشع لعدة جماجم، مما أعطى انطباعًا خاطئًا أن بعض البشر كانوا “بدائيين” أكثر مما هم عليه.
– اختلاق وثائق وشهادات مزورة.
– نسب بعض الجماجم لأشخاص غير أصحابها؛ مثال: جمجمة عمرها 250 سنة زُعم أنها تعود لـ”إنسان بدائي عمره 20.000 سنة”.
– محاولة بيع جماجم أثرية من أرشيف الجامعة في السوق السوداء.
والصدق صفة إنسانية من ثبتت في حقه فعلا وقولا ثم بالقرائن التي ترفع الريبة فهو صادق عند البشر فكيف بمن مات عليه ودعا له وحارب من أجله؟
ونفس الشخص النافي وجود صادقين ينفي عن الجنس البشري تفوقه في إحدى الصفات التي يحوز مقدماتها وقابلة لأن تكون، ﻷنه كما يوجد أعلم وأجهل وأعدل وأظلم يوجد أصدق وأكذب, وهذا أمر يقبله أصحاب العقول السوية بأريحية، أي من نفسك تعرف أن داخلك يحب الصدق حتى من غيرك وهذا يستلزم أن غيرك فيه الصادق وقابل ﻷن يكون.
وصاحب العلم المعجز الذي يتجاوز المقدمات المعهودة يقتضي منا تصديقه في كل ما يقوله ويؤديه ولا نحتاج في كل خبر إلى إعجاز لتبني هذا العلم أو إثبات صدقه فهو أصل عام يجري على كل فروعه من الأخبار واﻷفعال والتقريرات .
سيقولون: أعطنا دليلا على صدق النبوة؟ ونريد دليلا على البعث؟ أو العلم المعجز؟
فإذا سألته: ماذا تقصد بدليل؟ ترى صاحبنا متلعثما في الجواب، حينها أخبره: هل تريد علامة دالة على المدلول؟ إذا قال نعم، فقل له: إذا تريد آية؟
ولنبيّن هذا اﻹعجاز يجب أن تعرف “أن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم” وأن العلم منه الخفي يحتاج للنظر والتأمل والتدبر والتفكر ومنه الجلي، ولو كان كله جلي لكان طبعا ولم يقع التنازع ولارتفع الخلاف، وإذن لبطل الاختبار والابتلاء ولم يحضر الامتحان، ولو كان كله خفي لم يُتوصل إلى معرفة شيء منه إذ الخفي لا يعلم بنفسه وإلا صار جليا .
1- علماء الفيزياء متفقون على أن للكون بداية، أي أن الكون شيء حادث وكل حادث يستلزم محدث, العلم بهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال إذ يكاد يكون طبعا لولا الإديولوجيات المسبقة التي عندما صعدت لرأس الجبل وجدت أهل الدين ينتظرونها فتزعزعت هناك ثم اختارت الكبر, إذ اﻷولية ثابتة للمُوجد مع لوازم القوة المطلقة والعلم المطلق والقدرة أيضا.
يقول الفيزيائي الملحد آرثر إدنجتون: “فكرة بداية الكون بغيضة بالنسبة لي”.
2- دعوى ابتداء الخلق لم يقل بها أحد ﻷن حجاجه سيكون سهلا “اخلق ذبابة”, وما يعلمه كل بشري هو أن بشرا منا قالوا لقد أرسلنا من الخالق والمالك لكل شيء برسالات ونُبئنا بالوحي ولدينا دلائل مادية ومعنوية على صدقنا، معجزات وأخبار غيب.. بعثنا لنخبركم عن الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله وأن تعبدوه وحده وجئناكم بما يريده منكم وإنا لصادقون.
حجة الاتقان والضبط في الكون واضحة ومن تمامها ضبط تدبير المخلوقات وهدايتهم.
يقول الفيلسوف البريطاني أنتوني فلو في كتاب “هناك إله: كيف غَيَّر أشهر ملحد رأيه؟”: “أنا أؤمن حالياً أن هناك إله”، وقد كان سابقا ملحدا بارزا.
3- الوجود التاريخي للأنبياء قطعي ولا يجادل فيه إلا من سفه عقله, فبعضهم دوّن التاريخ بأحداث خاصة بهم كالميلاد والهجرة, ومنهم من آثاره نقلت بالتواتر الذي يفيد العلم القطعي إذ يستحيل في العادة أن يجتمع الناقلون على الكذب, فوجودهم أظهر من غيرهم.
فمثلا محمد عليه الصلاة والسلام لا يزال مسجده موجود وقبره وقبر صاحبيه ومنازل أصحابه وآثاره وأماكن غزواته بل أجزاء من القرآن كمخطوطات تعود للقرن اﻷول الهجري.
علق اﻷركيولوجي وليام ديفر على نقش تال دان بقوله إن عامة المتخصصين في النقوش القديمة –وكلهم ليسوا من أنصار التوراة– على أن هذا النقش يتحدث عن بيت داود، بما يشير إلى وجود حاكم اسمه داود.
4- الأنبياء آمن بهم على مرّ التاريخ أنواع من البشر، آمن بهم علماء مادة بمختلف مجالاتهم وعلماء فلسفة وعلماء أديان، كما آمن بهم العامي والمفكر وآمن بهم اﻷبيض واﻷسود والأحمر في مختلف بقاع العالم.
والاستجابة لهم كانت على مستويات عدة زمنيا وجغرافيا وعقليا أي طولا وعرضا، وهذا التنوع يمنع العقل من تبسيط المسألة ويدفعه إلى البحث فيها بجد ﻷنها حقا تدعو للتأمل والتفكر، نعم، خصوصا إذا علمت أنه حتى في أوقات ضعف تمكين رسالاتهم استمر هذا التنوع.
قال غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: “ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول”.
5- “الحكم على الشيء فرع عن تصوره“، فمثلا محمد عليه الصلاة والسلام رجل كان يعيش حياة قريبة من قومه في مكان قبلي لا يحتمل القصور والبروج العالية, نعلم ما كان متداولا بين قومه ودرجتهم العلمية في تلك الفترة. جاء بالنبوة التي حورب عليها من نفس قومه ثم الذين حاربوه سلموا له بها, حاربه أعمامه مما يعني أنه ليس شيء مبيت بين بني هاشم. وبعد النبوة ازدادت حياته قربا من الناس نساؤه أصهاره أصحابه المسلمون وغيرهم, في البيت خارج البيت وأيضا المسجد يبصرونه ويسمعونه, يبشرهم ثم تتحقق البشارة ويحيط به اليهود ويفحمهم. ادعى غيره النبوة في نفس المحيط الجغرافي فلم يفلحو, الروم والفرس لم يوقفوا انتشار دعوته, مبنى دعوته على الصدق أقر له به المقربون له، عاش به ومات عليه وحارب من أجله وانتصر واستمر.
تقول المستشرقة البريطانية كارن أرمسترونج في معرض دفاعها عن صدق أمية النبي محمد عليه الصلاة والسلام: “بعيدا على أن ذلك ليس من الأمور المعهودة ‘تعني الكتابة والقراءة عند العرب في تلك الفترة’، فإنه يبدو من العسير جدا المحافظة على هذا الغش , نظرا للتقارب الشديد في المعيشة بين محمد وقومه”.
6- الاقتراب من الحقيقية التجريبية في القرن السادس شيء صعب جدا, مثلا في علم الأجنة نجد كثيرا من الآراء العلمية في تلك الفترة تصادم العلم الحديث بداهة. إذا كيف لشخص أن يأتي بعدة حقائق علمية تجريبية في مختلف المجالات بل ومركبة هذا مستحيل في القرن السادس ﻷن اﻷصل استعمال المتداول خلال عصره وذلك لعدم توفر المقدمات العلمية واﻵليات المتقدمة, بل كيف يصادم اﻵراء العلمية البارزة في تلك الحقبة ويوافق ما توصلنا إليه حديثا؛ لو كان فقط اقتراب منه لكان عجبا أما موافقته تعدادا وتركيبا هذا يستلزم التسليم بصدق المصدر وعلمه.
يقول كيث مور عالم اﻷجنة والتشريح الكندي الشهير في المؤتمر الطبي الذي عقد في الدمام سنة 1981م: “ومن الواضح لدي بأن التقريرات القرآنية قد بلغت -قطعا- محمدا من الله، وذلك ﻷن كل تلك العلوم -تقريبا- لم يتم اكتشافها إلا بعد قرون عديدة بعد ذلك. وهذا يثبت لي أن محمدا هو قطعا رسول من الله”.
7- دعوة اﻷنبياء تتحيز للنظام والحكمة في مقابل العبثية تتحيز للعدل في مقابل الظلم، وكل اﻷصول العامة جاءت لحفظ مصالح البشر بما فيها النفس والمال والجزئيات تخدم هذه اﻷصول.
بشر لم يدّعوا أنهم خارقون لذواتهم بل مؤيدون من المُوجد للخلق -والكل يعلم أن العبثية لا تؤسس علوما مادية ولا تنشئ حكمة-، حثوا على طلب العلم، فمثلا محمد عليه الصلاة والسلام لم يُؤمر في القرآن بدعاء للازدياد من شيء غير العلم وهذه آثار علومه منتشرة في تدبير الدول وحفظ المصالح وإن كابر المستعمل لها.
يقول أستاذ الكمياء الملحد بيتر آتكينز: “العلم، النظام المؤسس بأمان على المعرفة القابلة للتكرار والمشاركة العامة، نشأ من الدين”، كتاب “خيال الطبيعة: حدود الرؤية العلمية” الذي حرره جون كورنويل ونُشر بواسطة أكسفورد.
8- الإخبار بالغيبيات المستقبلية طريق الوحي قبل ظهورها حتى أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بحوادث معينة منها التتر بما ثبت في الصحيحين عنه من غير وجه، قال “لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرفة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر”، فهل يتصور أن أي قياس أو علم تجريبي أو أطروحة نظرية ستعين حدثا سيقع وقد وقع فعلا، وتذكر آدمي معين أو أمة معينة مع هذه الصفات قبل ظهوره بسبعة قرون. بل قد بشر بالبيت الذي ببكة في كتب أهل الكتاب قبل النبوة الخاتمة وبتفاصيل عجيبة إذ أن التراجم الانجليزية للنص العبري ذكرته Vally of Becca بالاختلاف في بعض الحروف لكن المعتمدة منها كلها ذكرته بالحرف اﻷول كبير كدلالة على اسم المكان وأضافت أنه ستقرب إليه غنم قيدار وأكباش نبايوت وهم من أولاد إسماعيل ومعلوم مكانهم ومكان أبيهم.
وما أحسن عنوان كتاب البروفسور عبد الأحد داود، “محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب اليهود والنصارى”.
اﻷدلة تختلف مراتبها من عدة أوجه، فمثلا الأدلة النقلية منها المتواتر والآحاد، ونفس الآحاد هو أقسام مما يؤثر على قطعية النقل أو غلبة الظن فيه أو الإهمال ومدارها على صدق الحدث أو القائل.
أما الأدلة العقلية فمنها البديهي ومنها ما يحتاج لنظر واستدلال لبلوغ العلم فيه وصدق العاقل مؤثر. التجريبي حيزاه الكبيران الفرضية ثم الرصد وقابلية التكرار مثلا مع استصحاب صدق عالم المادة، الوجدان كعلم الإنسان بلذته وألمه.
ونقلا عن بن جزي “فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم: السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحدس وقرائن اﻷحوال”.