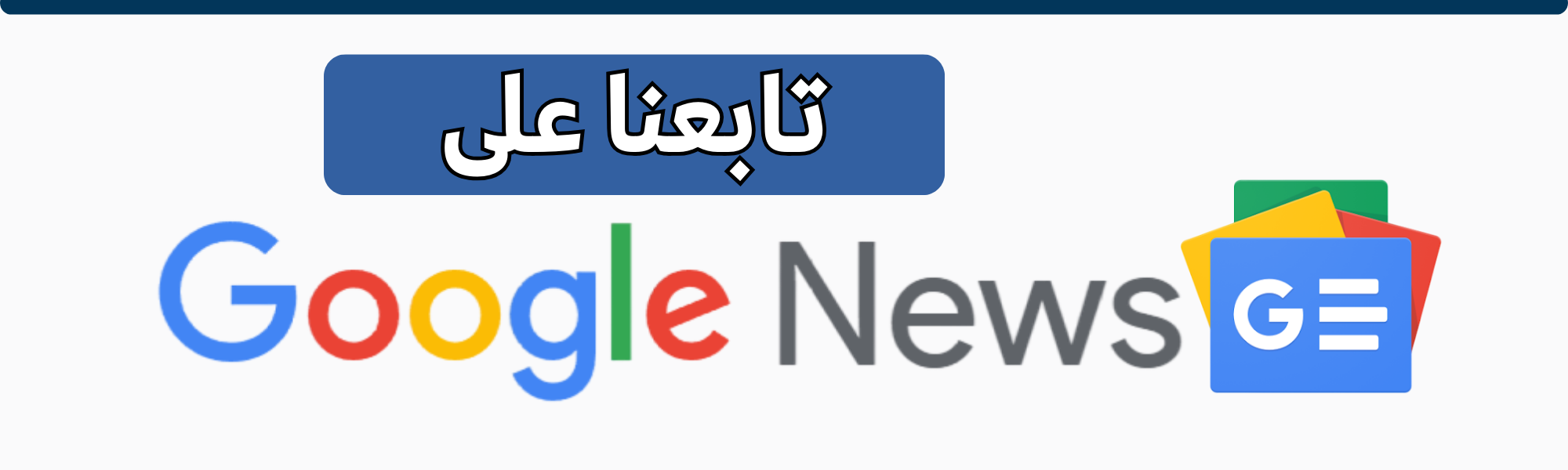تقع الملكية المغربية اليوم حبيسة أحزاب ونخب متكسبة وطبقة أوليجارشية غير منضبطة، بورجوازية طفيلية ورأسمالية متغولة، جمعت اليوم بين السلطة والمال، فضلت المغامرة مرة أخرى، كما فعل سلفها من قبل عام 1953، بارتهان مستقبل المغرب، ملكية ودولة، لدى أمريكا وفرنسا و”إسرائيل”، بدل أن تساعد الملكية على تطوير نفسها لتتأقلم مع الوضع المحلي والمتغيرات الدولية، وتتجاوز أزماتها البنيوية في مرحلة هي الأكثر دقة من ناحية انتقال الحكم من الملك إلى ولي عهده، ولو اقتضى ذلك الحفاظ على السيادة والعرش ونقل مسؤولية الحكم لنخبة وطنية مستقلة من أجل ضمان مستقبل الدولة المغربية وبقائها، دولة لا تمثل فيها الملكية، برأي فقهاء علم السياسة والقانون الدولي، سوى ركنا مشروطا من أركان الدولة، إلى جانب الشعب، حجز الزاوية للدولة وتكوينها، والإقليم، النواة الصلبة لقيام الدولة. نقول بأن الملكية لا تمثل سوى ركنا مشروطا بضوابط أساسية، هي توفرها على شرعية متجددة لنظامها السياسي، وممارستها للحكم فعليا لهذا النظام بالمعنى السيادي واستقلال القرار السياسي والاكتفاء الاقتصادي الوطني وتحقيق السلم الاجتماعي، والحضور الدولي لحماية المصالح القومية، والوقوف إلى جانب قضايا الأمة.
كانت الملكية المغربية تستمد شرعيتها من الدين والعرف قبل المرحلة الدستورية ابتداء من أول دستور لعام 1962، لكن فقهاء الدساتير الفرنسيين انتبهوا بداية الاستقلال التبعي وعقب تولي الملك الراحل الحسن الثانية الحكم، وأمام منافس قوي في الشرعية الوطنية والدينية، حزب الاستقلال، لعب دورا كبيرا في إعادة السلالة العلوية إلى المُلك عام 1955 بتصعيد المقاومة الجهادية والعمل المسلح ضد الاستعمار الفرنسي وأعوانه من العملاء المحليين، أمام هذا الفاعل الجديد على الساحة السياسية الذي كسب ثقة السلطان محمد الخامس بعد العودة من المنفى، لاحظ هؤلاء الفقهاء بأن تآكل شرعية الملكية العرفية والتاريخية الدينية، بسبب أخطاء في التقدير السياسي ودعوة فرنسا لحماية العرش كما جاء في وثيقة الحماية عام 1912، خلال حكم السلاطين عبد العزيز وعبد الحفيظ ويوسف وبداية عهد محمد الخامس، لذا، يجب أن تتحول لشرعية دستورية تنظم الحكم وتثبت مركزيته وقدسية الجالس على العرش بدون منازع، وثيقة تهندس وتؤطر لتراتبية العلاقة بين الملكية وبين حزب الاستقلال، وباقي الأحزاب فيما بعد، وتحدد قواعد اللعبة السياسية بين مؤسسات الدولة، فجاء دستور 1962 الذي وضع بنيته الفقيه الفرنسي موريس دو فيرجي، واقترح فيه القيادي الاتحادي المهدي بن بركة مؤسسة ولاية العهد، فيما كان اقتراح إمارة المؤمنين من طرف عبد الكبير الخطيب، وكل واحد منهم له حساباته وأهدافه.
إن أي اختلال في العلاقة بين الدولة ومكوناتها، الشعب والإقليم والنظام السياسي، وهو الملكية في حالة المغرب، من شأنه أن يعرض الدولة للضعف والابتزاز وتزايد الأطماع من قبل قوى داخلية أو أجنبية أو بتحالف بينها، وإن جعل الدولة في خدمة النظام السياسي فقط دون الشعب والإقليم، أو اختزال الدولة في النظام أو جعل الملكية فوق الدولة، كلها مخاطر تهدد الدولة وتحدث اضطرابا بين الشعب، المكون الأساس للدولة، وبين النظام السياسي الحاكم، بل إن تدخل بعض مؤسسات وأجهزة الدولة كطرف رابع مؤثر في العلاقة بين الملكية والشعب من شأنه كذلك أن يخلق مصالح وأهداف لا تخدم بالضرورة الدولة ولا مكوناتها الثلاثة، لأن المؤسسات العمومية هي مجرد مرافق تنفيذية بيد الحكومة لتحقيق السياسات العمومية لصالح الشعب وخدمة الملكية وبقاء الدولة. إن مسؤولية دولة أكبر من أن تكون مجرد سلطة وثروات بيد الحُكم، طبقة حاكمة وطبقة نافذة داعمة لها، فيما الشعب يعاني في حياته الاجتماعية والاقتصادية وفي مواطنته وكرامته وحقوقه، ويتعرض الإقليم المغربي للأطماع منذ أزيد من (500) سنة مع احتلال سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزر الخالدات، ومناطق على حدودنا الشرقية وانفصال موريتانيا واندلاع حرب الصحراء مع الانفصاليين المرتزقة، فأين هو النظام السياسي المسؤول دستوريا وشرعيا وسياسيا عن حماية الدولة ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية؟
لنفكك هذه المقولات من منظور تاريخي واجتماعي وسياسي وعمراني بالمعنى الخلدوني، عبر طرح سلسلة من الأسئلة الوجودية، هل الدولة قابلة للتفكك أو الاحتلال أو الزوال؟ هل الأنظمة السياسية، ملكية أو جمهورية أو إمارة، قابلة للسقوط أو الانهيار أو التعاقب؟ هل الشعوب، أعراقا وطوائف وديانات، قابلة للتهجير أو النزوح أو الانتقال من أرض لأرض ومن حدود لحدود ومن انتماء لانتماء؟ هل الإقليم قابل للتقسيم أو التوسع أو الانكماش؟ هذه أسئلة تطرح دائما عندما تكون البشرية، مجتمعات وأمما ودولا، بين مرحتين، الأولى انهيار لنظام دولي قديم ومنظومته القيمية والحضارية وإعادة هندسة خريطة القوة والثروة والنفوذ من جديد، وتفكك كيانات سياسية كانت بالأمس القريب دولا ذات سيادة ونظام اجتماعي، والثانية ولادة نظام دولي جديد بهوية قيمية ناشئة أو متجددة ترث تركة الأمم والدول المنهارة، وقيام دول جديدة على خريطة جيوسياسية جديدة يتوزع فيها النفوذ والثروة على أساس الغلبة والقوة وتقوم على الدين والقومية، السودان واليمن وسوريا نموذجا.
ويبقى النظام السياسي، الركن الثالث لتكوين الدولة، الحلقة الأضعف لانهيار الدولة إذا كان مضطربا أو فاقدا للشرعية أو هامشيا في صناعة القرار وإدارة شؤون الدولة أو دب الخلاف والصراع بين أفراده حول العرش، وتتقوى الدولة وتتمدد وتتحول إلى لعب دور قومي خارج الحدود وحماية مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي والدولي، بقوة النظام السياسي وحكمته وحنكة تدبيره ومؤسساته وتماسك نسيجه الاجتماعي وقواه السياسية وجيشه واقتصاده ورفاه مجتمعه. إن قراءة سريعة لتاريخ المغرب السياسي منذ سقوط السلالة السعدية عام 1659 وتولي السلالة العلوية الحكم ابتداء من عام 1661، وبعد فترة قوة وازدهار مع السلطانين إسماعيل وحفيده محمد بن عبد الله، 1672-1727 و1757-1790 على التوالي، وتحديدا ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، ومع هزيمة المغرب في معركتي إيسلي، عام 1848، وتطوان، عام 1859، تخبرنا بأن المغرب أصبح “موضوع العلاقات الدولية” بعد أن كان قبل ذلك “فاعلا في العلاقات الدولية”، بتعبير رئيس حكومة 1958، الراحل عبد الله إبراهيم، وأصبح المغرب محط الأطماع الأجنبية، بدأت بمعاهدة الجزيرة الخضراء عام 1906 وانتهت باحتلال المغرب من قبل إسبانيا وفرنسا عام 1912، ثم ضياع مناطق استراتيجية على حدوده الشرقية، ثم استقلال موريتانيا عام 1960 عن المغرب، وقبل ذلك بقرون استعمار سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزر الخالدات ابتداء من عام 1497، خمس سنوات بعد سقوط الأندلس عام 1492، لينتهي مسلسل الضعف وضياع الأرض بإعلان انفصال الأقاليم الصحراوية عن المغرب عام 1974 من طرف مرتزقة مدعومين من دول عربية وغربية وإفريقية ولاتينية بهدف فصل المغرب عن عمقه الإفريقي وخنقه من الجهات الأربعة، كيان مصطنع تابع للجزائر وقوى الاستعمار جنوبا، والجزائر شرقا، وإسبانيا شمالا.
إن تراجع مساحة إقليم الدولة وانكماشها، وهجرة السكان خارج إقليم الدولة لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وحقوقية، وفقدان النظام السياسي للرقابة على شؤون الدولة والمجتمع، وتحلل سلطته وتشرذمها إلى مراكز نفوذ متصارعة، وانتقال موقعها من المركز إلى المحيط، يؤدي حتما لتعرض الدولة للتحلل والفشل العضوي والتفكك مع الوقت، مما يحرك أطماع القوى الأجنبية نحوها للنيل من سيادتها واستقلالها واستغلال ثرواتها وشعبها وضمها لدوائر نفوذها وهيمنتها.
هذا ما وقع للدولة المغربية مع الاستعمار البرتغالي عشية انهيار الدولة السعدية عام 1659، ومع الاستعمار الفرنسي والإسباني عشية اندلاع ثورات عديدة في جل مناطق المغرب وصراع أبناء السلطان الحسن الأول بعد وفاته المفاجئ عام 1894، وتدخل المخزن وانحراف بعض رجالاته وتحالفهم مع قوى استعمارية أخضعت الدولة لاتفاقية فاس عام 1912 الاستعمارية وتقسيمها بين القوتين الغاشمتين، وتوقيع عريضة عزل ونفي السلطان محمد الخامس وأسرته عام 1953. هذا قانون الدول عبر التاريخ ومكره، القوي يحتل الضعيف ويخضعه لإرادته السياسية والعسكرية ويستغل ثرواته وموقعه الجيوسياسي الحيوي، ويوظف المقربين من السلطة الحاكمة لتدمير الدولة من الداخل كما فعل كل الغزاة عبر التاريخ.
سؤال مؤرق، أيهما أولى بالبقاء أو التضحية عند مواجهة خطر أجنبي أو فوضى داخلية، النظام السياسي أم الدولة أم اصطفاف النظام السياسي إلى جانب الدولة للدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها ودوامها، وبذلك يحفظ النظام السياسي لنفسه البقاء في السلطة ويكتسي شرعية الاستمرارية. لقد أجاب الملك الراحل الحسن الثاني عن مثل هذا السؤال عند حديثه عن قضية الصحراء الوطنية، بأنه في مثل هذه الحالة، فإنه كان مستعدا للتحالف مع الشيطان للحفاظ على وحدة الدولة الترابية وسيادتها وحماية مصالحها. إلا أن هذا لا يقع دائما، ولكل ملك أو سلطان حساباته وسياقه التاريخي، حيث إن السلطان عبد الحفيظ، وأمام ثورات عمت جل مناطق المغرب ضده وضد جهاز المخزن، وشعوره بخطر سقوط الحُكم، استعان بفرنسا لتوقيع اتفاقية فاس عام 1912 من أجل حماية العرش والأسرة الحاكمة، فماذا لو تغير السياق وتغير الرجال وتغيرت الحسابات؟
ومما يزيد في منسوب هذا القلق وحدته هو سلسلة من الأحداث تشهدها البلاد تضع الدولة والملكية على المحك بحيث يلاحظ تغير مواقع القرار والنفوذ بيد جهات تخرج يوميا، وبشكل متسارع ومستهتر، على المجتمع المسلم وعلى الملكية بصفتها، دستوريا، القائمة على حماية مؤسسات الدولة وثوابت الإسلام، من خلال عناوين ومنابر وأصوات تطعن في ثوابت الأمة، وتجر المغرب نحو الاحتراب حول أمر هو الأخطر على السلم الاجتماعي واستقرار الدول، مسألة الهوية والمعتقد، أبرزها مؤسسة الأسرة ومدونتها، وبيان العلمانية دخل قبة برلمان الأمة، وتغول التكنوقراط ورجال الأعمال بعد أن أحكموا قبضتهم على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى قطاع المال والأعمال، والاختراق الصهيوني لأوساط النخب حيث لم يعد المتصهينون يخفون تحالفهم مع الدولة العبرية ومشاريعها الصهيونية العالمية التي تستهدف الأمة، والمثلية العلنية كان أبرز تحديها للإسلام وثوابت الأمة المغربية مهرجان السينما بمراكش، دون أن ننسى التعديل الحكومي البئيس، والذي مررت من خلاله الطبقة التكنوقراطية المتغولة رسالة واضحة، هي أنه أصبح لها اليد الطولى في الدولة لتعين من تشاء من الوزراء والمسؤولين في مؤسساتها، فكان أكثرها عبثا وسقوطا وزير التربية والتعليم الذي لا يفلح في تركيب جملة واحدة مفيدة وسليمة باللغة العربية ويعجز عن الإجابة على الأسئلة في برلمان الطفل. فإلى أين تسير الملكية والدولة، هل ستتوحدا أم ستفترقا، هل سيضحى مرة أخرى بسيادة الدولة واستقلالها على يد “الكلاويين الجدد” كما حصل مرتان من قبل، مع الصدر الأعظم محمد المقري عام 1912 والباشا التهامي الكلاوي عام 1953، رجلا فرنسا داخل دار المخزن؟
هناك طرف ثالث لعب تاريخيا دور “رمانة القبان” لإفشال مشاريع “رجال فرنسا”، أضيف إليهم اليوم “رجال إسرائيل”، غداة توقيع اتفاقية الحماية عام 1912، وهم العلماء والزعماء، وكان على رأسهم الشيخ الشهيد عبد الكبير الكتاني، والمجاهد الأمير عبد الكبير الخطابي، صاحبا البيعة المشروطة في العهد الحفيظي، 1908، ومعركة أنوال المجيدة، 1921-1926، على التوالي، ثم قادة من حركة المقاومة وجيش التحرير غداة عزل السلطان محمد الخامس عام 1953 واستبداله بـ “ملك فرنسا”، محمد بن عرفة، واليوم نخبة من الوطنيين المستقلين من مختلف المواقع والأطياف المرجعية الإسلامية والوطنية، أو ما يسمى بـ “المعارضة غير المهيكلة”، التي تقف في وجه هذه الانحرافات السياسية والقيمية والإنسانية وتعريض الدولة، بل حتى الملكية، لخطر استعمار جديد ودسائس القصور، بمختلف أشكال التعبير السياسية والإعلامية والفكرية والحقوقية، وتحاول أن تنبه الجميع، ملكية ودولة ومجتمعا، بشأن ما تشكله الطبقة التكنوقراطية الأوليجارشية المتغولة بكل قطاعاتها واختراقاتها لمؤسسات الدولة من خطر على مستقبل الدولة المغربية، والملكية أيضا بالتبعية.
ويبقى القرار في اختيار مصير علاقة الدولة والملكية بيد الجالس على العرش، قرار، إذا كان لصالح الدولة وسيادتها واستقلالها، سيجعل النخبة الوطنية المستقلة تقف الموقف الوطني والحضاري المطلوب منها دفاعا عن استقلال البلاد، أما إذا ضيع القرار الموعد مع التاريخ ولم يختر الصف الذي سيقف فيه، فإن العواقب، هذه المرة، لن تكون في حدود ما وقع عام 1953، خاصة مع التهديدات الأجنبية والتغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم العربي، وبشكل أخص تبعات سقوط نظام بشار الأسد على الصعيد العربي، وأطماع القوى الغربية والروسية والصينية، وإنما ستكون العواقب وجودية ستفرض شرعا وعقلا إعلان المقاومة من أجل حماية الدولة ومكوناتها الأصلية والأساسية، الشعب والإقليم في حالة أعاد “الكلاويون الجدد” ما فعلوه مع الملكية عام 1953 ويلمحون إليه اليوم على لسان وزراء وقادة الأحزاب المهيمنة على مقاليد مؤسسات الدولة منذ سبتمبر 2021.
عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في إسبانيا يوم 23 فبراير 1981، واقتحام البرلمان، الكورتيس، من قبل قادة الانقلاب، بسبب معارضة الجيش وحلفاؤهم في الأوليجارشية النافذة، فوز الأحزاب الممثلة لمسار الإصلاح السياسي والدستوري الجديد الذي دشنته إسبانيا مع قوى سياسية اشتراكية وديمقراطية ليبرالية، عرض قائد الانقلاب ميلان ديل بوش على الملك السابق خوان كارلوس، مباركته لهذه الحركة العسكرية الانقلابية مقابل جعل الملكية في إسبانيا تنفيذية تسود وتحكم، إلا أن موقف الملك خوان كارلوس كان تاريخيا وحاسما ومتحيزا للديمقراطية والدستور، فقال قولته المشهورة لزعيم الانقلاب: “يأتي ملك ويذهب ملك، والثابت والأهم هي إسبانيا والدولة الإسبانية”، ثم أضاف له: “سأضمن لك محاكمة عادلة وآمرك الآن بالعودة للثكنات وتحرير البرلمان”، رمز الأمة وبيت ممثليها والعمود الفقري للدولة. كان هذا هو موقف الملك خوان كارلوس، رجل الدولة الذي اختار وقدم مستقبل الدولة الإسبانية واستقرارها وسيادتها على أي اعتبار آخر، بما فيها الملكية.