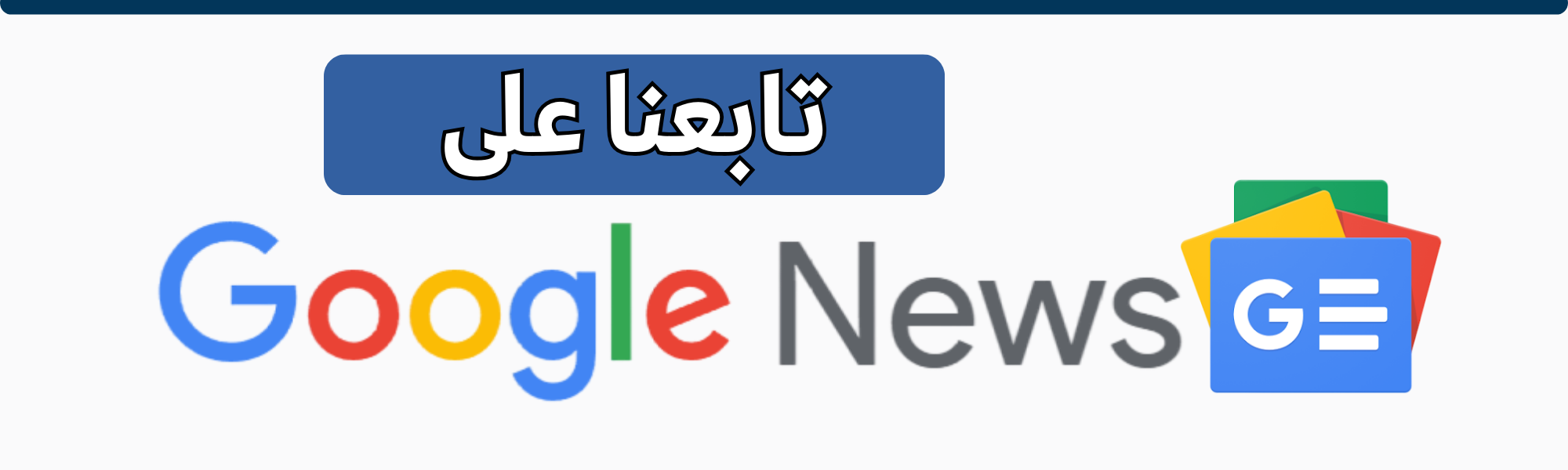بين مفهومَي العلم والتصنيف، وفقاً للعلماء المهتمّين بالتصنيف، علاقة أكيدة تتمثّل في الإدراك بالنسبة للأشياء المراد تصنيفها. فأول خطوة معرفة ماهيتها ومكوّناتها الأساسية وأوصافها الخارجية وما تتميّز به، ولا يتميّز ذلك إلا بالعلم وبمعية إحدى وسائله، وذلك حسب طبيعة الأشياء، وكذا الخصائص. فبعد التعرّف على المراد تصنيفها من طريق الإدراك، لا بدّ من استخلاص خصائص الأشياء ومعرفة الخاصية المشتركة بين مجموعة من الأشياء. ولا يتم ذلك إلا بالعلم، وتعتبر هذه الخطوة الثانية لعملية التصنيف، ويأتي أخيراً المعيار، وهو أساس التصنيف، وهو مقياس يميّز الأشياء بعضها من بعض، ويأتي بعد الإدراك ومعرفة الخصائص، وهذه الخطوة الأخيرة والأساسية في التصنيف.
غُرست شجرة العلوم الإسلامية منذ قدوم الرسالة الإسلامية، ورُويت بالنقل والعقل، حتى أثمرت المصنّفات المختلفة لعلوم الإسلام منذ القرن الثاني من الهجرة النبوية. وقد تحوَّلت المعارف في الحاضرة الإسلامية (بتعبير فرانز روزنتال) من “العلم” بالمفرد إلى “العلوم” بالجمع، وذلك لمَّا تكاثرت العلوم وتشعَّبت. تطلّبت النهضة العلمية التي ظهرت منذ القرن الثاني للهجرة وضع منهجيةٍ لتصنيف العلوم والمعارف تتّضح معها حدود كلّ علم، وكان أوّل من التفت إلى أهمية تصنيف العلوم، فلاسفةُ اليونان، فصاغ أفلاطون أوّل لبنة في صرح التصنيف وتبعه أرسطو، وجاء من بعدهما فلاسفة الإسلام. يتعذّر على الدارسين تحديد البداية الحقيقية لتصنيف العلوم عند العرب ضمن الحضارة الإسلامية، لكن هذه الظاهرة تطالعنا منذ أواخر القرن الثاني على يد جابر بن حيّان، غير أنها لم تكتسب قوّتها إلا في القرن الثالث، وبلغت أوجها خلال القرن الرابع تلبيةً للتطوّر المعرفي وتنوّع الروافد الثقافية وضروب المعارف التي تتطلّب مقايسة العلوم، وربّما المفاضلة بينها في بعض الأحيان. وكان أوّل من شرع في الاهتمام بتصنيف العلوم الفلاسفة والمفكّرين ذوي الصلة بالثقافات الأجنبية وخاصّة اليونانية، مثل الرازي والفارابي وابن سينا والتوحيدي، وبعض الورّاقين كابن النديم، ثمّ أدركهم علماء الشريعة في مرحلة لاحقة فصنّف كلٌّ من ابن حزم والغزالي والبيضاوي والذهبي، وغيرهم.
وبالنظر في المؤلفات الغزيرة التي خلّفها العلماء المسلمون نجدها تتوزّع ضمن اتجاهين: نظري فلسفي يقوم على إحصاء العلوم والتعريف بحدود كلّ فرع منها، ويمثّله الكندي والفارابي وابن سينا والحسن العامري وغيرهم من الفلاسفة، واتجاه تطبيقي لا يكتفي بالتعريف بحدود العلم، وإنما يدرج المصنّفات المندرجة فيه، ويعرّف بمؤلفيها فيما يشبه العمل البيبلوغرافي، ويمثّله ابن طيفور البغدادي في كتابه “أخبار المؤلّفين والمؤلفات”، وابن النديم في “الفهرست”، وحاجي خليفة في “كشف الظنون”؛ وقد أصبح “علم التصنيف” أو “ترتيب العلوم” أو “مراتب العلوم” علماً قائماً بذاته، وأُفرد بالتصنيف والتأليف فيه، وقد أُحصيت المصنّفات التي عُنيت بتصنيف العلوم فوصلت إلى أكثر من ثلاثين مؤلَّفاً؛ كما أوردها إبراهيم الإبياري في تحقيقه “مفتاح العلوم” للخوارزمي. وقد زاد بعضهم فوق ذلك بكثير، حتى أوصلها إلى قريب من تسعين عنواناً مستقلًًّاً في الباب.
تطلّبت النهضة العلمية التي ظهرت منذ القرن الثاني للهجرة وضع منهجيةٍ لتصنيف العلوم والمعارف تتّضح معها حدود كلّ علم
يتناول أمير دزيري موضوع “تصنيف العلوم” أو “مراتب العلوم”، ويحاول تلخيص الركام المتناثر من المعلومات في سردية تاريخية متماسكة يسهل عرضها وتتبُّعها، وجاء في مقدّمة المترجم محمود فتّوح: “شغل تصنيف العلوم (“ترتيب العلوم” و”علم التصنيف” و”تقاسيم العلوم”) موقعاً سجاليّاً كبيراً في تاريخ الفكر الإسلامي، وتباينت المقاربات والاتجاهات في هذا الحقل المعرفي، واضطربت مقاربة المصنّفين للفنّ الواحد من العلوم، فضلاً عن علاقته ببقية العلوم الأخرى، ومنذ وقت مبكِّر في تاريخ الفكر الإسلامي، شكَّل مفهوم (العلم) عنصراً أساسيّاً في الثقافة الدينية والأدبية، وستتطوّر هذه الحالة لاحقاً لتصبح سمةً عامّةً في الوعي الإسلامي، حتى إن فرانز روزنتال وصف العلم بأنه أحد المفاهيم الأساسية للحضارة الإسلامية، ومنذ نزول الوحي، كان للعلم دور رئيس في بنية التديّن الإسلامي، إذ ثمّة عهد من الإله للبشر بأن يهبهم من العلم ما يُدركون به العالم، ووعد اللهُ المؤمنينَ به والمنقادين لأوامره أن يدركوا بالعلمِ الكونَ من حولهم إدراكاً خاصّاً، وأن يصلوا بالعلم إلى كُنه غايتهم الإنسانية في هذا الوجود، بل وأن يعينهم العلم أيضاً في تدبير شؤونهم العامَّة”. وإن غضضنا الطرف عن اختلاف منهجيات المُصنّفين ومقارباتهم، فإننا نجدهم يتّفقون في نقطة مركزية، هي أن ترتيب العلوم وتصنيفها ليس غاية في ذاته، بل تقف خلف هذا التصنيف غايةٌ أخرى، وغالباً ما تكون غايةً تعليمية.
استلهام منظور المعرفة في الرؤية الإسلامية، القائم على أساس النسق التوحيدي، وأن المعرفة في أصل تصورها شجرة ثابتة الجذر واصلة بالساق مولدة لفروع مؤكّدة الثمار، تؤتي أكلها كلّ حين… هذا التصور المبدئي أهاب بأحد أهم المصنّفين للعلوم ابن فريغون، الذي ألف كتاباً حول “جوامع العلوم”، لينتج مؤلَّفه متبعاً طريقة التشجير، وصار مدخلاً تصنيفياً معتبراً، سواء كان ذلك لشجرة علوم التصنيف أو للتصنيف داخل علم بعينه؛ كمثال رائق ومثير للدهشة في تفريعاته العلمية، فالمؤلف يظهر الفروع العلمية في صورة مشجّرات علمية. ونجد مثل ذلك أيضاً عند أبي الحسن العامري في كتابه “الإعلام بمناقب أهل الإسلام”. يقول محقّق الكتاب “الكتاب يُعدّ نقطة تحوّل في علم التصنيف في مرحلته، وأنه يمثل ثمرةً لتطوّر كثير من العلوم والأفكار في فلسفة العلوم وأساسياتها المتعارف عليها”.
لمَّا تكاثرت العلوم وتشعَّبت، تحوَّلت المعارف في الحاضرة الإسلامية من “العلم” بالمفرد إلى “العلوم” بالجمع
كما يَعزو المؤرّخ وفيلسوف التاريخ ابن خلدون تطوّر العلم، من مفهومه الفردي إلى مفهوم جماعي عمراني لمختلف المعارف، إلى عاملَين. الأول التطوّر الكمي الواسع للعلوم ذاتها، سواء في استحداث علوم جديدة، أو بزيادة التدقيق والترقي (بمرور الوقت) في المعارف القائمة بالفعل. الثاني التمايز الجلي بين العلوم وبعضها بعضاً، ممّا سيجعل الحدود بين العلوم ظاهرةً مع الوقت أيضاً. وقد ولَّد هذان العاملان الحاجة إلى التصنيف والترتيب والتنظيم للعلوم، لا سيّما في الحواضر الكبرى من العالم الإسلامي، مثل بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة. وكان من آثار مثل هذا التطوّر للعلوم زيادة عدد المؤلفات والآداب الإسلامية، إن عملية التصنيف للعلوم كانت ضمن مشروعه العمراني، وضمن نظرته في التكامل ما بين العلوم في سياق عمران العلوم وعلوم الأمم، ومن أهم العناصر في تصنيفه هو تمييزه بين العلوم الحقيقية البانية والعلوم الفاسدة التي لا تقيم عمراناً ولا تحدث حضارة.
وها هو التوحيدي في رسالته للعلوم يتجوّل بين العلوم في سياقات وظيفية ليؤكّد أن لكلّ علم وظيفة يقوم عليها وبها وفيها، ضمن أسلوبه العميق والرشيق في آن، وضمن رؤية جامعة بين تلك العلوم وأدوارها، وكذلك في سياق حكمتها ونفعها، يؤكّد على ذلك ما استنفره لكتابة رسالته القصيرة والبليغة تلك، وها هو الجاحظ يحيلنا إلى مدخل منهجي متميّز في عمليات التصنيف نوعياً ضمن علوم البيئة ليوجّه النظر إلى نوع فريد من الاهتمام، خاصّة ما ضمّنه في موسوعته “الحيوان”، وشكّلت اهتمامات الجاحظ إبداعات في التأليف والتصنيف، وكذلك علينا أن نتوقّف عند العامري الفيلسوف المهضوم في حضارتنا الإسلامية، ليؤصّل مدخلاً مقارناً بديعاً جعل من مقارنة الأديان مجالاً له في كتابه المهم “الإعلام بمناقب الإسلام”؛ فيحدّد الأديان التي يقارن بينها؛ كما يحدّد موضوع المقارنة ومنهجها.
هكذا ظلّت المسألة التراثية تقع في قلب سؤال التراث من ناحية، وعمليات التصنيف التي ظلّت محلّ اهتمام كبير في الجهود التصنيفية وجهودها واجتهاداتها، وظلّ تصوّرها، والوعي بها، من مقدّمات التفكير في مسألة النهوض ومساراتها المعرفية والحضارية.